
الطائفية في العراق: تحليل نفسي-اجتماعي عبر عدسة النظريات العلمية
ناظم علي /كاتب عراقي
ليست الطائفية في العراق ظاهرة حديثة، بل هي نتاج تراكمات تاريخية عميقة الجذور، تفاعلت مع عوامل سياسية واجتماعية ونفسية. لكن السؤال الجوهري: كيف يمكن لصراعٍ طائفي أن يستمر قرونًا، رغم وعي الجميع بتداعياته المدمرة؟
حيث يختلف مفهوم "الظلم/المظلومية" مثلا، عند معظم السنة والشيعة؟ إذ ما يراه السني ظلما لبني جلدته في ايران أو العراق، هو غير ما يراه الشيعي. كما إن الظلم الذي ينظر اليه الشيعي اليوم في الساحل السوري هو غير مايراه السني!؟
تتطلب الإجابة تحليلًا علميًّا يعتمد على نظريات تفسر التفاعل بين العقل البشري والبيئة الاجتماعية. سنستند هنا إلى أربع نظريات رئيسة:
1. نظرية "العقل الراجح" لجوناثان هايت (الحدس الأخلاقي).
2.نظرية "التفكير بسرعة وبطء" لدانيال كانمان (الانحيازات المعرفية).
3. نظرية "الذكاء العاطفي" لدانيال جولمان (دور التعاطف).
4. نظرية "الانفصال الأخلاقي" لألبرت باندورا (تبرير العنف).
الإطار النظري: الطائفية عبر عدسة العلوم النفسية
يرى هايت إن القرارات الأخلاقية تُتخذ حدسيًّا أولًا، ثم يُبررها العقل لاحقًا. في العراق، تُشكّل الهوية الطائفية جزءًا من "الحدس الأخلاقي" الذي يربط الفرد بقيم الجماعة (مثل القداسة والولاء)، مما يجعل الانتماء الطائفي غريزة أولية، وليس اختيارًا عقلانيًّا. كما تختلف الأولويات الأخلاقية بين المذاهب. فبينما تركز احدى الجماعات على "حق الاغلبية"، تُقدّس أخرى "الولاء للجماعة" مما يخلق فجوات أخلاقية غير قابلة للجسر. ويرجع الباحث حارث حسن في تحليله لمركز تشاتام هاوس (2021) فشل الحركة الشعبية العراقية(2019) إلى عجزها عن تجاوز "الحدس الأخلاقي الطائفي" الذي تشكله التربية والبيئة الاجتماعية. فحتى المتظاهرين الذين رفعوا شعار "نريد وطناً" واجهوا اتهامات بالخيانة من داخل طوائفهم، مما يعكس هيمنة أساس الولاء/الخيانة.
من جانب اخر، يطرح كانمان أطروحة مفادها أن العقل يعمل عبر نظامين (مجازا):
- النظام 1 (السريع): يعتمد على الحدس والصور النمطية (مثل: "السنّة دو١١عش"، "الشيعة عملاء إيران").
- النظام 2 (البطيء): يحلل المعلومات بعقلانية، لكنه كسول ويُستبعد في الأزمات.
في العراق، يسود النظام 1 في الخطاب الطائفي، حيث تُستدعى الصور النمطية تاريخيًّا (مثل فاجعة كربلاء أو جرائم د١١عش) لتحفيز الغضب، دون مساحة للنقاش العقلاني. إن النقد والتحليل العلمي( البطيء) يكشف التحيزات، ويرصد الدوافع والمسوغات، ويصل لنتائج مختلفة، عادة ما لا ترضي أصحاب التفكير (السريع).
أما جولمان فيؤشر إلى أن انخفاض الذكاء العاطفي – خاصة التعاطف – يُغذّي الصراع. في العراق، أدت عقود من العنف إلى تجميد التعاطف مع "الآخر"، حيث يُنظر إلى معاناة الطائفة المخالفة عبر إطار "استحقاق العقاب". هذا يفسر صعود خطاب الكراهية حتى بين النخب المثقفة!
فتجد من يكتب وينشر وكأنه يحمل سلاحا، في الوقت الذي يفترض أن يكون فيه ضميرا حيا لوطن يبحث عن أمة (بتعبير فالح عبدالجبار)، ومجتمع بأمس الحاجة إلى من يعيد له صوابه.
في سياق الطائفية في العراق، يمكن تطبيق مفهوم فك الارتباط الأخلاقي أو الانفصال الاخلاقي لعالم النفس الاجتماعي ألبرت باندورا، لفهم كيف يمكن للأفراد والجماعات تبرير العنف والتمييز ضد الآخرين بناءً على الانتماء الطائفي.
1.التبرير الأخلاقي: في العراق، يتم تبرير العنف الطائفي أحيانًا على أنه دفاع عن المذهب أو الطائفة. على سبيل المثال، قد يرى بعض الأفراد أن العنف ضد طائفة أخرى هو وسيلة لحماية هويتهم الدينية أو الثقافية.
2.المقارنة التبريرية: قد يتم تقليل الشعور بالذنب تجاه العنف الطائفي من خلال مقارنته بأعمال عنف أخرى أكثر فظاعة. على سبيل المثال، قد يتم تبرير هجوم على طائفة معينة بأنه أقل ضررًا مقارنة بأعمال إرهابية أخرى.
3. إعادة التسمية: في الخطاب الطائفي، يتم أحيانًا إعادة تسمية العنف بأنه "دفاع عن النفس" أو "حماية للمقدسات"، مما يقلل من وقعها الأخلاقي.
4.تحميل المسؤولية للضحية: في بعض الأحيان، يتم إلقاء اللوم على الضحايا من الطوائف الأخرى، حيث يتم تصويرهم على أنهم سبب المشكلة أو أنهم يستحقون ما حدث لهم بسبب أفعالهم المزعومة.
5. نزع الصفة الإنسانية: في الخطاب الطائفي، يتم أحيانًا تجريد أفراد الطوائف الأخرى من صفاتهم الإنسانية، حيث يتم تصويرهم على أنهم "كفار" أو "خونة"، مما يسهل إلحاق الأذى بهم.
التحليل: الطائفية العراقية كنموذج معقد
أ. التاريخ كـ"ذاكرة جمعية مسممة"
الصراعات التاريخية (كالانقسام السني-الشيعي، أو سياسات صدام حسين القمعية) خلقت ذاكرة جمعية مُشبعة بالخيانة، تُنشطها أي أزمة عبر "الانحياز التأكيدي" (كانمان). فمثلًا، أي حدث عنيف اليوم يُفسَّر عبر منظور المظلومية التاريخية، لا الوقائع الموضوعية.
ب. السياسة كـ"مهندس للهوية"
بعد 2003، حوّلت المحاصصة الطائفية الهوية من بعدٍ ثقافي إلى وسيلة للبقاء السياسي والاقتصادي. هنا يتداخل حدس هايت الأخلاقي مع مصالح النخب، حيث تُستخدم القيم الطائفية لتبرير الفساد (مثال: توزيع المناصب بالانتماء، لا الكفاءة).
ج. الإعلام وخطاب الكراهية: تعطيل النظام البطيء
تعتمد القنوات الطائفية على إثارة المشاعر السريعة (النظام 1) عبر خطابٍ عاطفي يُغذي الخوف (مثل: "الطائفة الأخرى ستسلب حقوقك"). هذا يحدّ من قدرة الجمهور على التحليل العقلاني (النظام 2)، كما يوضح كانمان.
توصيات مستمدة من النظريات
1. تفعيل النظام البطيء (كانمان): دمج مناهج تعليمية تُعلّم التفكير النقدي وتفكيك الصور النمطية.
2. إعادة تعريف الحدس الأخلاقي (هايت): بناء خطابٍ يُبرز قيمًا جامعة مثل "العدالة للعراقيين" و "خطاب الدولة" بدلًا من "العدالة للطائفة" و "خطاب المذهب".
3. تعزيز الذكاء العاطفي (جولمان): تدريب القادة الدينيين والسياسيين على خطاب التعاطف.
4. محاربة الانفصال الأخلاقي (باندورا): فضح آليات تبرير العنف عبر الفنون والإعلام.
في المحصلة نجد معظم ابناء العراق، والشرق الاوسط يحملون ذاكرة مسممة، وثقافة متحيزة. شكلت مسوغاتهم النفسية. فمن السهل لديهم التعامل مع الماضي ليس كمعطى تاريخي مضى وانقضى، وانما بناء يتم تشكيله كل مرة حسب الظروف. والمشكلة الأساسية هنا أن غياب "الوعي بالزمن" يجعل من الماضي حاضرا ومستقبلا في أي وقت، فيصادر القادم لأجل الفائت!
إن الطائفية في العراق ليست لعنة أبدية، بل هي نتاج آليات نفسية واجتماعية يمكن تفكيكها. النظريات العلمية تقدم أدوات لفهم هذه الآليات، لكن الحلول تتطلب جرأة في إعادة هندسة المنظومة الأخلاقية والسياسية معًا.
نحن بحاجة إلى سردية تاريخية، وأخرى وطنية، تجمع العراقيين، وتنقذ أطفالهم من مستقبل مجهول. لأننا في الأساس نعيش في "ما قبل الدولة الحديثة" حيث نعامل كقطيع وليس كمواطنين وأفراد أحرار.
المصادر
1. Haidt, J. (2012). The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion. Pantheon Books.
2. Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux.
3. Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence. Bantam Books.
4. Bandura, A. (1999). Moral Disengagement in the Perpetration of Inhumanities. Personality and Social Psychology Review
















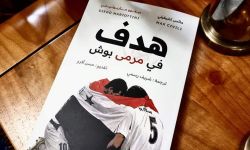
ارسال التعليق