
اوهام الحداثة والقطيعة مع الماضي
حسن الكعبي / كاتب عراقي
يقترن التراث والماضي في وعي بعض مثقفي الحداثة، بنسختها المتطرفة، بالعودة إلى الأساطير والانغلاق ضمن ماضٍ لا يسمح بامتداد التاريخ وسريانه.
تُعَدُّ هذه العودة في تصور هذا البعض تمثيلًا للأصولية وإعادة إنتاجٍ للاستبداد. أما البديل عن هذه العودة، فهو القطيعة مع الماضي ورموزه، والتخلص من هيمنة التاريخ الدائري، والتوجه نحو التاريخ الممتد؛ أي التاريخ بوصفه لحظةَ حضورٍ وإنتاجٍ لمفاهيم جديدة لا علاقة لها بالماضي. وهذا – بطبيعته – يُعَدُّ شرطًا أساسيًا من شروط الحداثة والتنوير في تصوراتهم.
حل الإشكاليات
إن النتيجة التي يتوصّل إليها المثقفون الحداثيون، المؤمنون بفكرة القطيعة مع الماضي، هي أن كلَّ مَن يؤمن بالماضي، فهو – بالضرورة – أصولي، وداعيةٌ للاستبداد، ومنقطع عن واقعه، ومنسجم مع أوهامه وأساطيره وخرافاته المهيمنة. بالمقابل، فإن كلَّ مَن يؤمن بالحاضر ومفاهيمه الحداثية والتنويرية، يُعَدُّ – بالضرورة – كائنًا يعيش لحظته التنويرية، التي تسمح بحل إشكاليات الاستبداد والتطرّف الأصولي، لمجرد القطيعة مع الماضي ورموزه، والإيمان بالحاضر وتجلياته الحداثية. أي بمعنى آخر: التخلي عن معطيات الماضي، والإيمان بالحاضر بوصفه تجسيدًا للآيديولوجيا الكونية التي تحتوي أطياف وتجليات الحداثة والتنوير والديمقراطية والليبرالية.
في هذا السياق، يمكن القول إن هذه التصورات تندرج ضمن خانة الأوهام والتطرّف؛ فالقطيعة التامة مع الماضي، والاندماج الكلّي بشرط الحاضر ومفاهيم الحداثة والتنوير، لا يُسهمان بالضرورة في حل الإشكاليات التي تحيط بواقع المجتمعات. فكما أن للماضي والموروث تحدياته ومشكلاته، فإن للحداثة أيضًا تحدياتها ومشكلاتها. من هذا المنطلق، يمكن الإشارة إلى أن الماضي – كما أنتج الاستبداد والظلامية والأساطير – فقد أنتج أيضًا لحظاته التنويرية والواقعية، وشروطه الإنسانية. فكما كان هناك عقل غنوصي كابن سينا، كان هناك أيضًا عقل تنويري واقعي كابن رشد، كما أشار إلى ذلك محمد عابد الجابري في نقده العقل العربي. بمعنى أنه كما يوجد “عقل سينوي” (نسبة إلى ابن سينا)، يوجد “عقل رشدي” (نسبة إلى ابن رشد). وكما وُجد عقل أفلاطوني مثالي، وُجد كذلك عقل سقراطي أو أرسطي واقعي.
ترسيخ الاستبداد
هذا الأمر يسري على الحاضر أيضًا؛ فمثلما أنتج الحاضر مفاهيمه الحداثية وشروطه التنويرية، فقد أنتج أيضًا مفاهيمه الاستبدادية. وكما كان هناك عقل نيتشوي عنصري في اللحظة الحداثية، وُجد أيضًا عقل إنساني كعقل سارتر أو ماركس. وكما يوجد مفكّر عنصري مثل دريدا، هناك مفكر إنساني مثل تيري إيغلتون أو إدوارد سعيد في لحظات ما بعد الحداثة. وفي هذا السياق كتبت نانسي هيوستن كتابًا مهمًا بعنوان (أساتذة اليأس)، أشارت فيه إلى أن الإنتاج النصوصي المتشائم في العصر الحديث هو المسؤول الأكبر عن ترسيخ الاستبداد، وقد أدرجت ضمن قائمتها عددًا من رموز الحداثة.
رموز إنسانية
ما نخلص إليه من هذا الطرح هو أن الماضي، مثلما يُنتج الاستبداد، فإنه يُنتج التنوير أيضًا. وكذلك الحاضر، فكما أنه يُنتج التنوير والديمقراطية، فإنه يُنتج الاستبداد والظلامية. ومن هنا، فإن القطيعة ينبغي أن تُفهَم على أساس التمييز؛ أي: تقبُّل الماضي ورموزه الإنسانية، ورفض واستبعاد روافده الاستبدادية ورموزه الظلامية. وهذا الأمر يسري على الحاضر أيضًا: أي تقبُّل رموزه الإنسانية والتنويرية، ورفض مظاهره الاستبدادية.
فالحاضر – كما أنتج رموزًا إنسانية كبيرة – فإن الماضي أيضًا أنتج رموزه الإنسانية الكبيرة. فهل يصحّ – مثلًا – التنكّر لرمزٍ إنساني كالنبي عيسى (عليه السلام)، وهو الداعية الأكبر للتسامح والتعايش الإنساني؟ أو التنكّر للإمام علي (عليه السلام) بما يمثله من عدالة وإنسانية متناهية، بدعوى القطيعة مع الماضي والتأسطُر؟ أو التنكّر للإمام الحسين (عليه السلام) الذي لا نزال نعيش ذكرى ثورته الإنسانية الكبرى ضد الاستبداد، بذات الدعوى؟ أو التنكّر لرمز إنساني كبير مثل النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهو الذي نادى بالتنوير، ونبذ الجهالات والعنصرية واحتقار النساء، ومحاربة الاستعباد؟ والأمر يسري كذلك على رموز إنسانية أخرى مثل غاندي، وجيفارا، وغيرهم من الرموز الإنسانية التي ينبغي استدعاؤها والاقتداء بها، لا التنكّر لها بحجّة أن استدعاءها يُعدّ رجوعًا إلى الأسطورة والعقل الخرافي، المُنتج للاستبداد.
















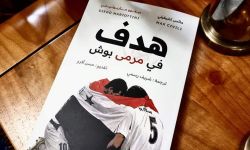
ارسال التعليق