
حين انكسر الزّمن في مرآة التّاريخ: هوبزباوم يكتب ما بعد الحلم
بسمة نايف صيموعة
بسمة نايف صيموعة/كاتبة وصحفية سورية
يُعرف عن الكاتب إريك هوبزباوم الذي وُلدَ في مصر تحديدًا في محافظة الاسكندريّة بأنّه مؤرخ بريطانيّ ماركسيّ، أحد أكثر العقول اتّساعًا في فهم حركة التّاريخ بوصفها جدلًا بين القوة والوعي، الثورة والنظام، انتمى إلى التّيار اليساريّ النّقدي الذي رأى في التاريخ صراعًا طبقيًا يتجاوز الحدود القومية نحو فهم الإنسان ككائنٍ اجتماعيّ مشدود إلى الحلم والخذلان معًا. في مؤلفاته الكبرى "عصر الثورة"، "عصر رأس المال"، "عصر الإمبراطورية"، "عصر التطرفات" رصد تحولات الحداثة منذ سطوعها حتّى انكسارها، وحين دوّى صدى ثورة الطلاب في باريس عام 1968، نظر إليها بإعجابٍ مشوبٍ بالريبة؛ رأى فيها طاقة احتجاج مشروعة، لكنها بلا عمقٍ اجتماعي يُسندها، فبدت له كبركانٍ ثقافيّ أكثر من كونها ثورةً تاريخية.
و في زمنٍ تبدو فيه الحضارة كبرجٍ كريستاليّ يلمع بقدر ما يتشقق، يقف إريك هوبزباوم -المؤرخ البريطاني الراحل- ليتأمّل من علياء القرن العشرين في كتابه "أزمنة متصدّعة" ما خلّفه الإنسان من أنقاض الأفكار والأخلاق والجمال، إذ لا يكتب التّاريخ كما يفعل المؤرّخون التقليديّون، بل ينعى الحضارة الحديثة، كمن يحدّق في مراياها المتكسّرة باحثًا عن ملامح كانت ذات يوم وعودًا كبرى بالتّقدم والحريّة والعقل.
يكتب هوبزباوم بلغة المؤرخ الذي يعرف أنّ التاريخ لم يعد حكاية أبطال، بل سردًا للخيبات التي تكررت بأسماءٍ جديدة، فيرى القرن العشرين -قرن العجائب والفظائع- كمرحلةٍ بلغ فيها الإنسان ذروة قدرته التقنية، لكنه خسر قدرته على الإيمان، فالمشكلة ليست في تغيّر العالم، بل في انعدام معرفة القصد من وراء التغيير، فيقول "لم يعد التّاريخ طريقًا نحو هدف، بل حركة بلا بوصلة، تكرار بلا نبوءة، ومصيرٌ بلا خلاص" من هنا، يصوغ هوبزباوم فلسفته في الزمن الحديث داخل عالمٍ متشظٍّ، بلا مركز ولا يقين، فالحداثة التي وُلدت على وعد العقل والحريّة تحوّلت إلى آلية عمياء تحكمها السوق، والأيديولوجيّات التي بشّرت بالعدل انتهت إلى دول بوليسية، أمّا الفنون التي أرادت تحرير الإنسان تحولت إلى سلع تنافسيّة تحكم قبضتها الإعلانات، مما أدّى إلى بثّ الحياة ومعانيها في كلّ شيء ما عدا الإنسان نفسه.
لكنّ ما يجعل "أزمنة متصدعة" كتابًا يتجاوز التأريخ هو حسّه الفلسفيّ الحزين، فهوبزباوم لا يكتب عن التاريخ بوصفه وقائع، بل كجغرافيا للوعي الإنساني وهو يتفتت، يطلّ القلق في كل فصلّ بعيدًا عن الاستعراض الحضاريّ مؤديًّا دوره كجوهر الوجود الحديث "هذا الإنسان الذي يقف على ركام أفكاره، يحدّق في الرماد محاولاً تذكّر النار"
وفي حديثه عن المثقّفين، تبدو نبرة الوداع واضحة "لم يعد المثقف نبيًّا أو ضميرًا، بل شاهدًا يدوّن سقوط المعنى في عالمٍ لا يريد أن يسمع" وهنا يبرز عمق المرارة التي تعتري القارئ العربي، فكم من مثقفٍ عربيٍّ صار شاهدًا على انكسار أمّته، لا لقصور في فكره، بل لأنّ الواقع طرد كل فكرة لا تناسب القيد.
إنّ الزمن المتصدع الذي يصفه هوبزباوم ليس غربيّا فحسب، بل عالمي في جوهره، فالغرب فقد المعنى وسط فائض الحريّة، في حين أنّ الشّرق تاهت بوصلته نحو المعنى وسط فائض الخوف، وكأنّ الحضارتين تواجهان النّتيجة نفسها بطرقٍ متعاكسة: الأولى تُخدّرها المتع والخيارات، والثانية تُخنقها القيود والتّابوهات، وفي الحالتين، يضيع الإنسان الذي كان محور التاريخ وصانعه.
يتوقف الكاتب طويلًا عند الثقافة الجماهيريّة، بوصفها الخدعة الأنيقة التي تسللت من قلب السّوق إلى روح الفن، فيقول بحدةٍ تليق بشاعرٍ أكثر من مؤرخ "حين يصبح الجمال سلعة، يفقد الفن قدرته على أن يكون إنسانيًا" ومع ذلك، يصرّ على البحث عن ظلّ الفنّ رافضًا إعلان موته، وإرادة المبدع بقول "لا" في وجه العبث، فالفن -من وجهة نظره- هو الذّاكرة الوحيدة التي لم تلوثها المصلحة، والاحتجاج الأخير ضد اللامعنى.
تسكن هذا الكتاب فكرةٌ خفيّة تبدأ ببطء تآكل الحضارة من الدّاخل -أي لا تموت بالانفجار- حين يتراجع الضمير، ويُستبدل السؤال بالإعلان، والحقيقة بالترند. ومن هنا يقترب الكتاب بكونه مرثيةٍ للقرن الذي وعد بالكمال، وانتهى بالفوضى، ومع ذلك، هناك شوقٌ عميق إلى النّهوض، كأنّه يُحذرنا من هول حجم التصدع، ويدعونا إلى الاستعجال بالتّرميم.
وحين نقرأ "أزمنة متصدعة" بعيونٍ عربيّة، نكتشف أنه ليس كتابًا عن أوروبا وحدها، بل مرآة للخراب الكونيّ الذي نسكنه جميعًا، فالانقسام بين التّقدم الماديّ والركود الروحيّ هو ما يعصف اليوم بمجتمعاتنا أيضًا، نعيش الحداثة كقشرة لا كجوهر؛ نمتلك الهواتف الذكيّة لكننا نفتقد الحوار، نبني الأبراج العالية وننسى أنّ الإنسان ما زال في الأسفل يبحث عن المعنى، مما يدفعنا -من حيث لا يقصد- إلى بعض التساؤلات: هل يمكن للعرب أن يتجاوزوا تصدعاتهم دون أن يواجهوا أنفسهم؟ هل يمكن لثقافةٍ تتهيّب النّقد أن تُشفى من الجهل؟ كيف يمكن لمجتمعٍ يخاف السؤال أن يحلم بالحرية؟ هذه الأسئلة لا يجيب عنها الكتاب مباشرة، لكنها تتسلل من بين جمله كما يتسلل الضوء من بين الشّقوق.
يُحلل الكتاب بتجرّد العالم الذي انتهى، ويتنبأ لعالمٍ قادم، عن الإنسان الجديد الذي يعيش داخل شاشته، ويقيس وجوده بعدد المتابعين، الكائن الذي تملّكه الصمت، وهروبه من التّأمل، لأنّه لا يقوى على مواجهة مُخلّفات فراغ الأفكار الكبرى بعد سقوطها، فعظمة هذا الكتاب تكمن في جرأته على الاعتراف باليُتم الحضاريّ، وإصراره على أنّ الخلاص يكمن بالوعي لا بالحنين، فهوبزباوم لا يبكي الماضي، بل يحذّر من تكراره. وفي واحدة من أجمل اقتباساته: "التاريخ لا ينتهي، لكنه يتقن التّنكر في وجوهٍ جديدة"
ولهذا السبب لا يزال كتابه حيًّا بعد رحيله، لأنّه يوقظ الحيرة التي تسبق الفهم خارج نطاق جهوزيّة التّفسير! وهنا يكتمل البُعد الفلسفيّ لعنوانه، فالزّمن لا يتصدع في الأشياء، بل في العقول التي كفّت عن التفكير، والقلوب التي توقفت عن الإحساس، وفي المجتمعات التي رضيت بأن ترى في التّصدع جمالاً ولم تجرؤ على الترميم، وحين ننتهي من قراءة الكتاب، يوقظ فينا التّالي: هل ما زال في هذا العالم مكانٌ لزمنٍ غير متصدع؟ أم أننا جميعًا، كما كتب هوبزباوم ذات مرة "نعيشُ في متحفٍ يزداد اتساعًا كل يوم، حيث نعرض الذكريات بدلا من صنع التّاريخ"














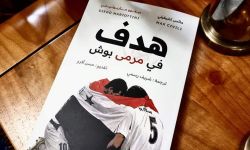
ارسال التعليق