
من فقه العبادات والمعاملات إلى فقه الدين وفقه الدولة نحو إطار حضاري جديد للفقه الإسلامي
محمد عبد الجبار الشبوط
محمد عبد الجبار الشبوط
مقدمة
اعتاد الفقهاء، وبخاصة في المدرسة الإمامية، أن يُقسّموا الأحكام الشرعية إلى بابين كبيرين هما العبادات والمعاملات. وقد أدّى هذا التبويب وظيفته في العصور التي كان فيها ثقل الحياة الفقهية منصبًّا على أداء الشعائر وضبط المعاملات الفردية، مثل البيع والشراء والزواج والطلاق والمواريث. غير أن هذا التبويب أصبح قاصرًا عن الاستجابة لاحتياجات العصر الحديث، الذي تَحَكَّمَت فيه المؤسسات العامة، وبرز فيه مجال الدولة بقوة، وصارت حياة الفرد والمجتمع مرتبطة بقرارات وسياسات تُصاغ على مستوى الدولة لا الفرد.
من هنا تأتي الحاجة إلى تطوير هذا التبويب، وإعادة النظر فيه، واقتراح تقسيم جديد يقوم على ثنائية:
1. فقه الدين
2. فقه الدولة
ويُعنى كل باب بما تعنيه كلمتا «الدين» و«الدولة»، وفق رؤية حضارية شاملة تنطلق من نظرية المركّب الحضاري، ومن المظلّة القيمية المكوّنة من اثنتي عشرة قيمة تمثل الأساس الأخلاقي للدولة الحضارية الحديثة: الحرية، العدالة، المساواة، المسؤولية، الإتقان، التضامن، التعاون، الإيثار، التسامح، الثقة، السلام، الإبداع.
أولًا: معنى فقه الدين وفقه الدولة
——————————————-
• فقه الدين: هو الفقه الذي يُعنى بالشعائر التعبدية، والعقائد، والأخلاق الفردية، وكل ما يربط الإنسان بخالقه من جهة، وبضميره الأخلاقي من جهة أخرى. وهو فقه يُعطي الأولوية للتوقيف، واليقين، والامتثال، ويهدف إلى بناء الفرد القيمي.
• فقه الدولة: هو الفقه الذي يُعنى بالشأن العام، وتنظيم السلطة، والعلاقات بين الدولة والمجتمع، والاقتصاد، والحقوق، والسياسات العامة، والعلاقات الدولية. وهو فقه يُعطي الأولوية للمصلحة، والمقاصد، والعقل العمومي، ويهدف إلى بناء المؤسسة القيمية.
ثانيًا: الجذور التاريخية للتقسيم القديم
—————————————————
كان تبويب «العبادات والمعاملات» انعكاسًا لطبيعة الحياة الاجتماعية في العصور الأولى. ففي المجتمع الزراعي-التجاري البسيط، كان الفرد هو محور النشاط، وكانت الدولة إطارًا محدود التدخل. ولذلك، ظلّت كتب الفقه حافلة بآلاف الصفحات عن تفاصيل الصلاة والطهارة والبيع والطلاق، بينما اقتصرت مباحث السياسة الشرعية على بضعة فصول ملحقة.
ومع ظهور الدولة الحديثة، ودساتيرها، ومؤسساتها، وتداخلها العميق في حياة الناس، برزت الحاجة إلى إعادة ترتيب الفقه بطريقة تعكس مركزية الدولة، لا على حساب الدين، بل في تكاملٍ معه.
ثالثًا: فقه الدين – مجال بناء الإنسان القيمي
———-———————————————
فقه الدين يركّز على تزكية الفرد، وضبط سلوكه الداخلي والخارجي، وتوجيهه نحو القيم العليا. وهو يتناول:
1. العبادات: الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة (بوصفها عبادة).
2. العقائد: الإيمان بالله، والنبوة، والمعاد، وما يتفرع عنها من رؤية كونية.
3. الأخلاق الفردية: كالصدق، والأمانة، والرحمة، والإحسان.
ويتجلى دوره في غرس القيم الاثنتي عشرة على المستوى الفردي:
• الحرية: تحرر الإنسان من عبودية الهوى والغير.
• العدالة: أن يكون منصفًا في نفسه ومع أسرته.
• المساواة: احترام الآخرين دون تمييز.
• المسؤولية: شعوره بواجباته الدينية والأخلاقية.
• الإتقان: أداء العبادة والعمل بإحسان.
• التضامن: مساعدة المحتاجين.
• التعاون: مشاركة الخير مع الناس.
• الإيثار: تغليب المصلحة العامة حتى على حساب نفسه.
• التسامح: الصفح عمن أساء إليه.
• الثقة: بناء علاقات قائمة على الصدق.
• السلام: نشر الطمأنينة في محيطه.
• الإبداع: الاجتهاد في العبادة وإحياء السنن.
بهذا يصبح فقه الدين وسيلة لبناء الإنسان القيمي، وهو الركن الأول من أركان المركب الحضاري.
رابعًا: فقه الدولة – مجال بناء المؤسسة القيمية
————————————————————-
فقه الدولة يُعنى بتنظيم المجال العام، وإدارة الشأن المشترك، وترجمة القيم العليا إلى سياسات وتشريعات ومؤسسات. ويمكن تفصيله في المباحث التالية:
1. الفقه الدستوري: الشرعية، العقد الاجتماعي، الشورى والديمقراطية المبكرة (﴿وأمرهم شورى بينهم﴾)، الفصل بين السلطات، التداول السلمي للسلطة.
2. الفقه الإداري: المشروعية، الاختصاص، الحوكمة، الشفافية، الرقابة.
3. الفقه المالي والاقتصادي: الضرائب، الموازنة العامة، العدالة التوزيعية، محاربة الفساد، السياسات النقدية.
4. الفقه الجنائي والقضائي: الحدود والتعازير، السياسة الجنائية، ضمانات المحاكمة العادلة، درء العقوبة بالشبهة.
5. حقوق الإنسان والحريات العامة: حرية الدين والضمير (﴿لا إكراه في الدين﴾)، حرية التعبير، المساواة أمام القانون.
6. فقه العلاقات الدولية: السلم والحرب، المعاهدات، المواثيق الدولية، حق اللجوء.
7. فقه السياسات العامة: التعليم، الصحة، البيئة، العمران، التحول الرقمي.
ويتجلى دوره في تجسيد القيم الاثنتي عشرة على المستوى المؤسسي:
• الحرية: كفالتها في الدستور والقوانين.
• العدالة: إنشاء قضاء مستقل.
• المساواة: إزالة كل أشكال التمييز.
• المسؤولية: ربط السلطة بالمحاسبة.
• الإتقان: اعتماد معايير الجودة في الإدارة.
• التضامن: وضع نظم للضمان الاجتماعي.
• التعاون: تعزيز العمل المؤسسي بين أجهزة الدولة والمجتمع.
• الإيثار: تقديم المصلحة الوطنية على المصلحة الفئوية.
• التسامح: حماية التنوع الديني والثقافي.
• الثقة: بناء مؤسسات شفافة خالية من الفساد.
• السلام: اعتماد السلم كخيار استراتيجي داخلي وخارجي.
• الإبداع: رعاية البحث العلمي والتجديد الحضاري.
بهذا يصبح فقه الدولة وسيلة لبناء المؤسسة القيمية، وهي شرط أساسي لقيام الدولة الحضارية.
خامسًا: الفرق المنهجي بين فقه الدين وفقه الدولة
—————————————————————
• فقه الدين يقوم على التوقيف واليقين، بينما فقه الدولة يقوم على المقاصد والمصالح المتغيرة.
• فقه الدين يخاطب الضمير الفردي، أما فقه الدولة فيخاطب العقل العمومي والمؤسسات.
• فقه الدين شرعيته من الامتثال، أما فقه الدولة فشرعيته من العدل وسيادة القانون.
سادسًا: التأصيل التراثي والمعاصر
——————————————-
• الماوردي وأبو يعلى في «الأحكام السلطانية» قدّما بذورًا لفقه الدولة.
• ابن تيمية وابن القيم في «السياسة الشرعية» أبرزوا دور المصلحة والعدل.
• الشاطبي في «الموافقات» نقل مركز الثقل إلى المقاصد.
• النائيني في «تنبيه الأمة» صاغ فقهًا دستوريًا ضد الاستبداد.
• الكواكبي في «طبائع الاستبداد» نقد تديين الطغيان وربط الحرية بالدين.
• مالك بن نبي قدّم نظرية الفاعلية الحضارية (الإنسان/التراب/الوقت).
• الفكر الغربي الحديث (لوك، روسو، مونتسكيو، فيبر، هابرماس، راولز) أرسى مبادئ الدولة الدستورية والعقل العمومي.
سابعًا: الربط بنظرية المركب الحضاري
————————————————-
• الإنسان: يُزكّى بفقه الدين.
• الأرض والوقت: تُدار بفقه الدولة.
• العلم والعمل: يُفَعّلان عبر السياسات والمؤسسات.
• منظومة القيم: الاثنتا عشرة قيمة هي الميزان الذي يربط فقه الدين وفقه الدولة ويمنع الانفصال أو الاستبداد.
ثامنًا: تمييز لا فصل
————————-
هذا التقسيم الجديد ليس دعوةً للفصل بين الدين والدولة على الطريقة العلمانية الغربية، بل هو تمييز منهجي يضمن:
• حماية الدين من التسييس والابتذال.
• حماية الدولة من التقديس والتعطيل.
• تحقيق تكامل بين الفرد القيمي والمؤسسة القيمية، تحت سقف المظلّة القيمية.
خاتمة
———
إن الانتقال من تبويب «العبادات والمعاملات» إلى «فقه الدين وفقه الدولة» يُمثّل نقلة نوعية في التفكير الفقهي، لأنه يعكس الواقع الحضاري الحديث، ويضع الفقه في قلب المشروع النهضوي. وبذلك يتحقق التلاقي بين الإنسان القيمي الذي يصوغه فقه الدين، والمؤسسة القيمية التي تُنشئها فقه الدولة، تحت راية القيم الاثنتي عشرة التي تُشكّل المظلة الأخلاقية للدولة الحضارية الحديثة.
#الدولة_الحضارية_الحديثة















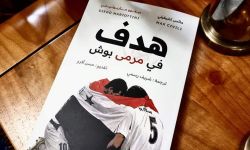
ارسال التعليق